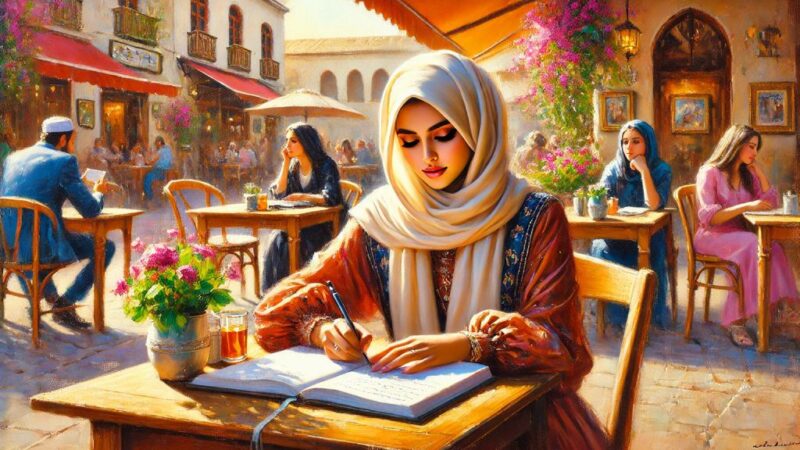محاولة لفهم “كلمة السواء” عند جودت سعيد وعلاقته بقانون النفع العام وانتقال السلطة من جهاز العنف إلى جهاز المعرفة

إنّ مفهوم “كلمة السواء” واحدٌ من المفاهيم القرآنية العميقة التي تتجاوز الإطار الديني الخاص لتشمل الإطار الإنساني العام. حيث تجسّد هذه العبارة في آيات القرآن الكريم جوهرًا مشتركًا يدعو إلى توحيد الله تعالى من جهة، وإلى إقامة علاقات اجتماعية وسياسية عادلة خاليةٍ من التألّه والاستعلاء البشري من جهةٍ أخرى. ومع توسّع الفهم القرآني والرؤية الكونية إلى الحياة، نجد أنّ مفهوم “كلمة السواء” يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقانون النفع العام الذي نصّ عليه القرآن في غير موضعٍ، وبخاصةٍ في قوله تعالى:
(فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَـمْكُثُ فِي الأَرْضِ) [الرعد: 17].
كما أنّ لهذا المفهوم دورًا جوهريًّا في الانتقال التاريخي من سلطة العنف إلى سلطة المعرفة؛ ذلك التحوّل الذي يُمثّل قمة الوعي الإنساني حينما يغدو العقل أداةً للحكم، بدلًا من القوّة القاهرة.
في هذه المقالة المطوّلة، سنحاول أن نُفصّل الحديث حول أبعاد “كلمة السواء”، ونربطها بالنفع العام من ناحية، وبقضيّة الانتقال من شريعة العنف إلى شريعة الفكر والمعرفة من ناحيةٍ أخرى، مع أمثلة واقعية تشرح هذا المفهوم على الصعيد التاريخي والحضاري.
التعريف بمفهوم “كلمة السواء”
1. أصل التعبير ودلالته القرآنية
يرد مصطلح “كلمة السواء” في القرآن الكريم في قوله تعالى:
(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ) [آل عمران: 64]
وقد خُصِّصت الآية بدعوةٍ من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب، ودعوةٍ لكلّ المختلفين في العقائد والشرائع، كي يحتكموا جميعًا إلى “كلمةٍ سواء”. والسَّواء في اللغة يدلّ على العدل والاستقامة والمساواة؛ أي كلمةٌ تتساوى فيها الحقوق والواجبات، ويتساوى فيها الناس أمام الدين وأمام بعضهم بعضًا.
وإذا حاولنا توسيع هذا الفهم إلى الإطار الاجتماعي والسياسي، وجدنا أنّ “كلمة السواء” تعني كلمةً تؤكّد المساواة على أساسٍ من العدالة والحقّ، وترفض وضع البشر فوق البشر في منزلة الألوهية أو الاستبداد. أيْ أنّها دعوةٌ إلى توحيد الله ونبذ الطاغوت، ورفض التألّه البشري والاستكبار الذي يُمثّل العقبة الأهم في بناء أيّ نظامٍ اجتماعي عادل.
2. الجذر الديني والاجتماعي للمفهوم
إنّ “كلمة السواء” تحمل وجهين متكاملين:
- الوجه الديني: يدعو إلى توحيد الله تعالى، ونبذ الشِّرك، وعدم الخضوع لغير الله؛ فلا يسع الإنسان أن يعبد مخلوقًا أو يستسلم لاستكباره.
- الوجه الاجتماعي والسياسي: يتبلور حين تصير هذه الدعوة أساسًا لإرساء مبدأ العدل بين أفراد المجتمع، بحيث لا يسمح لأحدٍ أن يَستَعبد الآخرين تحت أي مسوّغٍ من المسوّغات. فالنبيّ عليه الصلاة والسلام حين قال لأهل الكتاب: “تعالوا إلى كلمةٍ سواء”، جمع بين الدعوة الإيمانية والتوجّه الاجتماعي نحو إنهاء الاستعلاء، لأن التوحيد الخالص يُلغي التأليه البشري.
قانون النفع العام في ضوء الآيات القرآنية
1. قاعدة “ما ينفع الناس يمكث في الأرض”
من أهمّ المرتكزات التي يقوم عليها الفهم القرآني للتاريخ والمجتمع، تلك القاعدة التي أشار إليها القرآن في سورة الرعد:
(فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ) [الرعد: 17]
يشبّه الله تعالى الباطل بالزبد الذي يعلو الماء في جريانه، ولكنه سريع الزوال؛ لأنه بلا أساسٍ راسخٍ من الحقّ. في حين يشبّه الحق بما ينفع الناس، فيبقى ويستقرّ. ومن هذا المنطلق، يمكننا أن نفهم حتمية انتقال المجتمعات والأفكار والأنظمة من نماذجٍ أقلّ نفعًا للناس إلى نماذج أكثر نفعًا وعدلًا.
ولا ينحصر معنى النفع هنا في المنافع المادية فحسب؛ بل يشمل -قبل ذلك- المنافع الفكرية والمعنوية والحقوقية والأخلاقية التي تحفظ للإنسان كرامته.
2. أمثلة تاريخية على قانون النفع العام
- الثورة الزراعية: حين اكتشف الإنسان الزراعة واستأنس الحيوان، استقرّت المجتمعات وزاد الإنتاج الغذائي؛ فمكث هذا الأسلوب في الأرض وخدم البشرية، لأنه أكثر نفعًا من حياة التنقّل والالتقاط.
- اختراعات تقنية: كلّ اختراعٍ أو تقنية أثبتت جدواها للبشرية عمومًا –مثل الكهرباء والطباعة والإنترنت– بقيت واستمرّت وتطوّرت مع الزمن، في حين تهاوت أفكارٌ أو أنظمةٌ تقنية لم تثبت فائدتها أو أخفقت في خدمتها للإنسان.
- أنظمة سياسية: الأنظمة القائمة على الظلم والقهر قد تستمر لفترةٍ بفعل قوة السلاح، لكنّها سرعان ما تتهاوى حين ترتفع كلفة بقائها، أو حين تتنامى قوّة الأفكار التي تكشف ظلمها. بينما الأنظمة التي تحفظ حقوق الإنسان وتصون الحريات تكتسب صلابةً على المدى البعيد، لأنها تخدم النفع العام.
علاقة “كلمة السواء” بقانون النفع العام
1. “كلمة السواء” مبدأٌ لتحرير الإنسان
يكشف لنا القرآن نموذجًا تاريخيًا فارقًا هو التوحيد الذي دعا إليه الأنبياء جميعًا. فهذا التوحيد يحمل بالضرورة رفضَ الطواغيت وقانون الاستبداد، ونجد هذا المعنى جليًّا في الدعوات المتكررة إلى الخروج من عبادة البشر إلى عبادة ربّ البشر. وبهذا يتحرّر الإنسان من الخضوع الأعمى لسلطة جائرة.
إنّ هذا التحرير الديني يوازيه -بل ويدعمه- تحريرٌ اجتماعي وسياسي؛ إذ من خلال “كلمة السواء” تنقشع مظاهر الظلم والتفاوت القهري، ويرتفع وعْي الناس بقدرتهم على اختيار أفضل السُّبل لحياتهم المشتركة. وهنا يلتقي الدين بالسياسة في نقطةٍ مركزية واحدة: التحرر من كلّ ظلمٍ أو تألّهٍ بشري.
2. النفع العام أساس بقاء “كلمة السواء”
إنّ “كلمة السواء” ليست فكرةً ميتافيزيقية عابرة، بل هي القيمة التي تثبت نفعها للمجتمعات تاريخيًّا. فكلُّما ساد العدل واحترمت حقوق الناس، وانخفض معدل العنف المجتمعي، شعر الناس بنفع تلك المبادئ في حياتهم، فتمسّكوا بها ودافعوا عنها. ولذلك، فإنّ المجتمعات التي تنفتح على قيم المساواة والعدالة والديمقراطية، تحظى باستقرارٍ أكبر من تلك التي تُحكم بالاستبداد وقمع الأصوات. ولو وجدت بعض الأنظمة الدكتاتورية صلابةً وسطوةً ظاهريةً، فإنّها تظلّ عُرضةً للانهيار عند أول منعطفٍ تاريخي؛ لأنها تخالف سنة “النفع العام” القائمة على إشراك الناس واحترامهم.
انتقال السلطة من العنف إلى المعرفة
1. التأريخ البشري لشريعة العنف
عبر التاريخ، سادت قوانين القوة الغاشمة؛ حيث يفرض الحاكم أو السلطان أو الزعيم المستبدّ قراراته على الناس، مستندًا إلى تفوّقه العسكري أو الدكتاتوري. وكانت هذه الحال تعبيرًا عن مرحلةٍ سابقةٍ من تطوّر الوعي الإنساني؛ إذ لم يكن في إمكان المجتمعات المبكّرة أن تستوعب سلطة القانون المجرَّد، بسبب ضيق الأفق في المعرفة والمؤسسية. ولذلك، تحدّث القرآن عن طغيان فرعون الذي قال لقومه:
(أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى) [النازعات: 24] ليدلّ على نموذج الاستبداد الذي يجعل الحاكم إلهًا على شعبه لا يعترف بأية معارضة أو مساواة.
2. دور المعرفة في تحطيم الاستبداد
لقد شكّل تطوّر العقل البشري وازدياد تراكم المعرفة من خلال الرمز واللغة والفكر، الأساس الحقيقيّ للانتقال من سلطة العنف إلى سلطة القانون والفكر. فحين يكتشف الإنسان أنّه قادرٌ على إدارة أموره وفق قيمٍ فكريةٍ عليا، وأنّ الحوار أفضل وسيلةٍ لتسوية الخلافات، يبدأ بالتحرّك نحو نظامٍ اجتماعي وسياسي أكثر إنصافًا.
ومن هنا، تنبع إشارة القرآن إلى قيمة “الهداية” والمعرفة؛ إذ إنّ الله تعالى قد أنعم على الإنسان بالعقل والبيان ليصل إلى الحقيقة من دون حاجةٍ إلى نزاعٍ عنيفٍ. وفي قصص الأنبياء جميعًا، نجد الصراع بين قوّةٍ ماديةٍ مستبدةٍ وجماعةٍ صغيرةٍ تملك البرهان وتدعو بالحكمة. ومع الزمن، ينتصر صوتُ الفكر وينهزم صوت العنف، أو تهتزّ أركانه على الأقلّ.
3. أمثلة معاصرة على انتقال السلطة إلى المعرفة
- نهاية حقبة الاستعباد: في القرون الماضية، كانت أغلب الحضارات تُجيز استرقاق الأسرى والمتغلَّب عليهم، لكنّ انتشار الأفكار الفلسفية والإنسانية والدينية التي ترفض الاستعباد ساهم في تحريم الرقّ قانونيًّا على مستوى العالم.
- بزوغ دساتير حديثة: أغلب الدول المعاصرة تضع دساتير مُعترَفًا بها تسمو على إرادة الحاكم الفرد، وتضمن الحريات الأساسية. وهذا ينطوي على الارتقاء بقيمة العقل الجمعي لاختيار القوانين، بدلًا من فرضها من قِبل سلطانٍ أو عائلةٍ حاكمةٍ.
- التقنية والاتصال الجماهيري: إن الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أدّت إلى ثوراتٍ هائلة في مجال الوعي. وصار بإمكان الناس أن يتشاركوا المعلومات ويتبادلوا الرأي في دقائق، ممّا جعل من المستحيل تقريبًا على الأنظمة المستبدّة أن تحتكر كل الأصوات. وهذا يوضّح كيف تسود المعرفة -ولو تدريجيًّا- على سلطة العنف.
دور المثقّفين وأولي العلم في تكريس “كلمة السواء”
1. “كلمة السواء” ليست حكرًا على الدعاة الدينيين
إن كانت “كلمة السواء” دعوةً أطلقها القرآن في إطارٍ إيماني، إلا أنّ جوهرها الإنساني يتجاوز الانتماءات؛ فهي دعوةٌ إلى المساواة والعدالة والتعاون على الخير. ولهذا، يسع المثقفين وأصحاب الرأي -أيًّا كان خلفيّاتهم- أن يحملوا هذه الشعلة. فالمجتمع محتاجٌ إلى وعيٍ وإدراكٍ بأنّ الاستبداد لا يخدم النفع العام، وأنّ أفضل الأفكار هي التي تنفع غالبية الناس وتحفظ كرامتهم.
2. مسؤولية “أولي العلم” في مواجهة الاستبداد
إذا كان الطغيان ينشأ حين يستسلم الناس للباطل بدافع الجهل أو الخوف، فإنّ مهمة أصحاب العلم والمعرفة تتمثّل في توعية الناس وإزالة الغشاوة عن أبصارهم.
- التثقيف العام: عبر نشر قيم النقد البنّاء، وفضح الحجج الواهية التي يتذرّع بها أي مستبدّ.
- التشجيع على الحوار: حين تُناقش القضايا الحسّاسة بالمنطق والبرهان، يفقد الخطاب العنيف جزءًا كبيرًا من تأثيره.
- تقديم البدائل: فمهما انتقدنا الاستبداد أو الظلم، يبقى على أهل العلم أن يطرحوا بدائل عملية قابلة للتطبيق في السياسة والاقتصاد والقانون.
3. مسؤولية المجتمع ككلّ
لا يمكن للتغيير أن يتمّ بجهود صفوةٍ قليلةٍ من المثقفين ما لم يواكبهم أفراد المجتمع بالتدرّب على التفكير المستقلّ. وذلك يشمل اكتساب مهارات الوعي النقدي واحترام حقّ الاختلاف والنقاش الحرّ. وفي هذه الحالة تتحوّل “كلمة السواء” من مبدأ نظري إلى ثقافة شعبية عامة.
أمثلة تطبيقية تربط المفاهيم ببعضها
1. تحريم الخمر (نموذج قرآني لقانون النفع)
عندما تعرّض القرآن لموضوع الخمر والميسر، ذكر أنّ فيهما منافعَ للناس ولكنّ ضررهما أكبر من نفعهما. فنشأت قاعدة تغليب المصلحة العامة على المنفعة الجزئية. وهنا تتجسّد فكرة النفع العام بشكل واضح: إذا كان ضررُ الأمر أكبر من فائدته الإجمالية، فإنه يُطرَح ولا ينال حق البقاء في حياة المجتمع. وهذا المبدأ نفسه حاضرٌ في كلّ حظرٍ قانوني معاصر لموادّ أو ممارسات تضرّ أغلبية الناس.
2. تحرير الرقّ (صعود الوعي بالإنسانية)
شهدت القرون الأخيرة حملةً عالميةً لإنهاء الرقّ؛ وهي فكرةٌ تتناسب مع مبدأ “كلمة السواء”؛ إذ لا يستوي الناس في وجود عبوديةٍ يفرضها القويّ على الضعيف. ومع تراكم الوعي الحقوقي والديني والإنساني، صار الرقّ محرّمًا دوليًّا. هذا دليلٌ ساطعٌ على انتقال السلطة من قوّة العنف (المستعبد المتسلّط) إلى قوّة المعرفة والقيم الإنسانية التي تقدّم مصلحة الجميع.
3. الثورات السلمية المعاصرة
شهد التاريخ الحديث ثورات سلميّة عديدة مثل ثورة المهاتما غاندي في الهند ضد الاستعمار البريطاني، وثورة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة بقيادة مارتن لوثر كينغ. وفي كلتيهما، اعتمد القادة على قوّة المعرفة والوعي الشعبي، لا على السلاح. وانتصرت الحركات في النهاية لأنّ ما ينفع الناس من تحرّرٍ ومساواةٍ كانت له الغلبة؛ فهو أقوى من السلطة المتمثلة بالقوّة المادية.
آفاق “كلمة السواء” في المستقبل
1. صياغة عقد اجتماعيّ قائم على المساواة
إنّ السعي إلى “كلمة السواء” اليوم قد يتحقق في إطار دساتير عادلةٍ تعترف بتعدد الآراء والمعتقدات وتضمن الحرية والكرامة للجميع. ويُفترَض أن تُترجَم قيمة المساواة إلى نصوصٍ قانونيةٍ واضحةٍ تحمي حقوق الأقليات وتحاسب المسيء أيًّا كان موقعه.
2. العمل على تعزيز “الحوار العالمي”
في عالمٍ متشابكٍ اقتصاديًّا وثقافيًّا، لا يمكن أن نصل إلى استقرارٍ حقيقيّ إلا بالحوار العاقل الذي يعترف بتنوّع البشر ويضع مصلحة الإنسانية جمعاء فوق نزاعات القوّة والهيمنة. إنّ “كلمة السواء” حين تُنفّذ على مستوى عالميّ، تستطيع أن توفّر أرضيّة مشتركة تحكم العلاقات الدولية وفق قواعد القانون الدولي العادل، لا منطق الحروب والتدخلات العنيفة.
3. دور التربية والتعليم
لكي تعلو سلطة المعرفة، وتترسخ المساواة في النفوس، علينا أن نعدّل منظوماتنا التعليمية نحو تعويد الطلبة على التفكير النقدي وقيم السلام وحقوق الإنسان. وفي ظلّ تعليمٍ يُعزّز قيم “كلمة السواء”، سينشأ جيلٌ واعٍ بدوره الاجتماعي، متفهّمٌ لمعنى العدالة الشامل الذي يسع الجميع.
ختاماً: نحو تكامل الدين والقانون والمعرفة في بناء المستقبل
إنّ مفهوم “كلمة السواء” ليس مجرّد دعوةٍ عابرةٍ وجّهها القرآن لأهل الكتاب فحسب؛ بل هو إطارٌ فكريٌّ وأخلاقيٌّ يتّسع للبشرية بأسرها، ويدلّ على أنَّ التوحيد الحقيقي لله تعالى يرتبط بتحرير الإنسان من عبادة أيّ بشرٍ أو عبادة أيّ هوىً متألّه. كما أنّه يُحتّم على الإنسان بناء النُّظم الاجتماعية والسياسية على قاعدة العدالة والمساواة ومراعاة مصالح الناس كافّة.
ومن خلال قاعدة النفع العام (وأمّا ما ينفع الناس فيمكث في الأرض)، يتبيّن أنّ المسيرة البشرية وإن تخلّلتها فترات من التراجع والعنف والاستبداد، ستؤول في النهاية إلى التقدّم نحو قيمٍ أكثر إنسانية، لأنها أكثر نفعًا للناس. وفي هذا السياق، تأتي دعوة الأنبياء والمصلحين والمفكرين إلى تغليب قوّة الفكر على قوّة السلاح؛ فتنتقل السلطة شيئًا فشيئًا من قبضة العنف إلى رحاب المعرفة والحكمة والعدل.
وفي ختام هذه المقالة المطوّلة، يمكن القول إنّ مستقبل البشرية رهينٌ بمدى إدراكنا لهذه المعاني: كلمة السواء (المساواة والعدل)، وقانون النفع العام (ما ينفع الناس يمكث)، والانتقال من العنف إلى المعرفة (الحوار والبرهان بدل الإكراه). وليس ذلك بمستحيلٍ على مجتمعاتٍ تؤمن بالإرادة الإنسانية الخيّرة والسنن الإلهية العادلة، وتجد في القرآن الكريم وفي التراث الإنساني المشترك جذورًا صلبة تدفعها نحو حياةٍ أوفر حريةً ورخاءً وسلامًا.
المقال مستمد من كتاب “الدين والقانون” للمفكر جودت سعيد
كتب بواسطة تشات جي بي تي